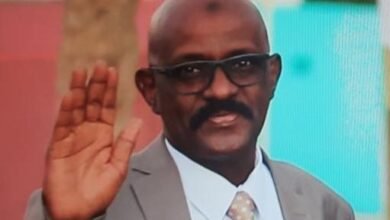محمدين محمد اسحق القيادي بحركة العدل والمساواة السودانية يكتب:-
بين (حنين) و(قارفي) والطريق الطويل نحو الحرية والتحرر
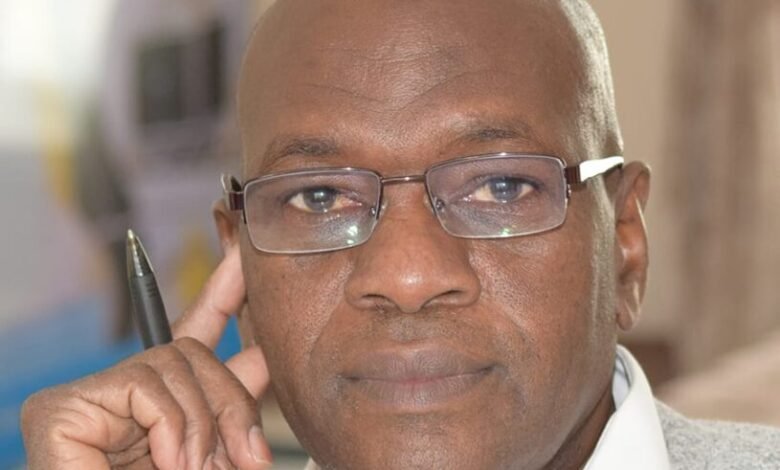
(الحلقة الثالثة)
الشعب الذي لا يعرف تاريخه الماضي، اصوله وثقافته..
هو كشجرة بلا جذور.
(ماركوس قارفي)
تحدثنا في الحلقة الاولي والثانية في هذه السلسلة عن الأفريكاني العظيم ماركوس قارفي احد آباء (البان افريكانيزم). لكننا لم نتحدث عن من هو (حنين) والصلة التي تربطه بقارفي، ولعل السؤال هنا في هذه اللحظة وربما منذ المقالة الاولي، من هو حنين؟ بالضبط مثلما جاء في الفصل الأول من كتاب دارفور.. حركة العدل والمساواة ورواية خليل ابراهيم.. لمؤلفه البروفيسور عبد الله عثمان التوم وقام بترجمته من اللغة الانجليزية عبد الرؤوف محمد آدم. بدأ الفصل الأول بالسؤال :- من هو حنين؟ وكان الرد علي لسان صاحب الاسم الحقيقي والذي نقله الكاتب عنه بانه (أنا حنين ابراهيم محمد حنين جوري سالم طه كوريا عبد الله بارو إسي عمر محمد داج) اذأ بطلنا الآخر كما يتبين هنا هو الشهيد د. خليل إبراهيم أو حنين اسمه الذي ولد به.. ولكن السؤال هنا هو ما الصلة بين قارفي أو الافريكانية أو حركة عموم افريقيا ، وبين الشهيد د. خليل إبراهيم؟
عودة الي قارفي فقد ذكرنا أن تعاليم الرجل ووصايه الي اتباعه أن طريق التحرر من العبودية يبدأ بالتحرر الذهني اولا قبل التحرر الجسدي.. والعبودية التي يتحدث عنها قارفي لم تكن عبودية اغلال وسلاسل تحيط بالإنسان (الافريقي)، وإنما هي عبودية فكرية وسياسية واقتصادية. عبر عنها روبرت نيستا مارلي بقوله في اغنية غابة الاسمنت- Concrete Jungle
لا قيود تحيط بمعصمي..
لكنني لست حرأ
ما أدركه أنني مقيد هنا بالعبودية..
No chains around my feet
But I’m not free
I know I’m bound here in captivity!
قارفي وضع خطوات واضحة وصارمة لاتباعه للتحرر من هذه العبودية تبدأ بمعرفة التاريخ والماضي الافريقي التليد. وفي هذا الصدد لديه مقولة مشهورة تقول:-
الشعب الذي لا يعرف تاريخه القديم، واصوله وثقافته
هو مثل شجرة بلا جذور!
هذه المقولة باتت قاعدة أساسية ليس لاتباعه فحسب بل لكل أنصار البان افريكانيزم في الشتات أو في القارة الأفريقية نفسها.. فالتحرر من الاستعمار الفكري يبدأ بمعرفة الإنسان لتاريخه واسلافه والتنقيب عن تراثه وثقافته التي حاول الاستعمار دفنها فيما يمكن تسميتها بالابادة الثقافية للشعوب الاصلية وهذه عملية امبريالية بامتياز طبقت في افريقيا والامريكيتين تجاه السود والهنود الحمر وكذلك في استراليا وفي مناطق اخري من أنحاء العالم لكن بدرجات أقل. وعملية غسل الأمخاخ أو العبودية الذهنية هي حالة استمرارية يمكن لها ان تستمر بوجود الاستعمار أو عدمه عبر وكلائه المحليين مثلما حدث في افريقيا والحالة السودانية تعتبر خير نموذج لاستمرارية العبودية الذهنية التي تتحكم في الدولة في كافة قطاعاتها التنفيذية والاقتصادية والاجتماعية والايدولوجية. وفي هذه الحالة يصلح كذلك ايراد القراءة التحليلية العميقة التي قدمها الافريكاني المارتينيكي الدكتور النفسي فرانتز فانون في كتابه (وجوه سوداء بأقنعة بيضاء) وفي ظني أن هذا الكتاب استلهم منه الدكتور الباقر العفيف كتابه (متاهة قوم سود ذوو ثقافة بيضاء) والذي خصصه لتحليل أزمة الهوية السودانية.
في ظني أن العبودية أو الاستعباد الفكري أخطر انواع العبودية لأنها كما ذكرت عملية مستمرة بدأت من المستعمر واستمرت عبر وكلاءه- حكومات وطنية- وقد تستمر اذا لم يحدث التحرر والانعتاق منها، ليس عبر الوكلاء فحسب بل عبر المستعبدين انفسهم وذلك حين يحدث تطبيع كامل لحياة العبودية الذهنية في فكر وسلوك المستهدفين بالحرية والتحرر، مع أو بدون وكلاء المستعمر الأجنبي، إذ لا حاجة حينها للمستعمر وقيوده وعصاه بل الكل بات يقيد نفسه بقيود من استعبده طويلا.
بالتأكيد هناك متشابهات عدة بين أزمة الإنسان الافريقي المسترق (بفتح الراء)/ المستعمر (بفتح الميم) في دول الشتات، وأزمة الإنسان السوداني في افريقيا والذي يعيش أزمة هوية أنتجت حروبأ في مناطق عدة من البلاد وساهمت في في فصل جزء عزيز منه ليشكل دولة مستقلة عن السودان الكبير.
الفرق الوحيد هو في ان الأول ينحدر من أسلاف اخذوا بالقوة من أوطانهم الأصلية بواسطة القوي الامبريالية ليبنوا ما سمي بالدنيا الجديدة. فيما الثاني يعيش فيما يحسبه وطنأ له لكن بعقلية وذهنية لا تنتمي الي هذا الوطن، والأنكأ والأمر هو انه يستخدم أدوات المستعمر (بكسر الميم) نفسها ليقود مواطنيه الي نفس أزمته.
كما قلنا فإن ماركوس قارفي كان يري الحل فيما يتعلق بأزمة الهوية والعبودية الفكرية يتمثل في العودة الي الجذور والهوية والثقافة الأفريقية، والاعتماد علي الذات، والتحرر الاقتصادي والفكري والعقائدي عن منظومة المستعمر الابيض.
قارفي في سبيل التحرر من الامبريالية العنصرية لم تحده حدود، إذ رأي أن الدين والثقافة البيضاء هي أدوات استعمارية يجب كذلك الانعتاق عنهما، فكانت له تفسيراته للكتاب المقدس وكما ذكرنا انه كان قد بشر اتباعه وذلك قبل أن يضع قدمه علي السفينة التي ستقله من موطنه جامايكا الي امريكا، بظهور الملك الأسود الذي سيحرر السود من الاستعباد الابيض حيث قال:-
(انظروا الي افريقيا، حيث سيتوج ملك اسود قريبأ، حينها سيكون هو المخلص للجنس الأسود)- وذلك بناء علي تفسيره للمزمور ٦٨-٣١ (من مصر يأتي الشرفاء وتمد اثيوبيا -كوش- قريبأ يدها الي الرب).
وصادف أنه بعد أكثر من عقد من الزمان علي مقولته هذه، أن توج الرأس (تافاري ماكونان) – هيلا سيلاسي امبراطورا علي اثيوبيا وذلك في العام ١٩٣٠. وللمفارقات أن النبوءة هذه وبزعم تحققها باتت تشير الي بداية اضمحلال وتلاشي الحركة القارفية مقابل نشوء حركة جديدة هي الحركة الراستافارية التي اتخذت الامبراطور هيلا سيلاسي الهأ، وبات عندها بذلك نهاية البحث عن الإله الأسود. فكرة الاله الأسود ليست جديدة فقد نشأت قبل ذلك في افريقيا وعبر كنائس وطنية حاولت أن تشكل تصوراتها الخاصة عن الدين المسيحي وعن صورة المسيح المتخيل كإنسان ابيض وأم بيضاء، يحيط بهما ملائكة بيض، لكن قارفي وفي سبيل التحرر العقائدي عن المسيحية البيضاء رسخ في اذهان اتباعه الإيمان بمجيء المسيح الأسود، الذي مثله البعض في امبراطور اثيوبيا. المفارقة الاخري التي تتجلي هنا، أن قارفي لم يؤمن بألوهية هيلا سيلاسي قط ولم يعترف به حتي كمحرر ومنقذ للجنس الأسود من الهيمنة الامبريالية. وعلي العكس من ذلك هاجمه كثيرأ ووصفه بالجبان الذي هرب من أرض المعركة وترك قومه فريسة للقوي الاستعمارية، وذلك بعد غزو إيطاليا للحبشة ولجوء هيلا سيلاسي وأسرته الي بريطانيا. هذه أمور قد نعود لها لاحقا وفي مقالات نقدية منفصلة عن الحركة القارفية والراستارفية، لكن هذا الاستطراد كان مهما هنا لتبيان الفوارق والمشتركات بينهما وصلة ذلك بقارفي ولاحقأ بحنين أو الشهيد د. خليل إبراهيم.
(يتبع)